الاجتهاد الزائف
الوصف: ليس في الإسلام كهنوت يحتكر التكلُّم باسم الله، أو تفسير الوحي، أو الاستئثار بالمعرفة الدي
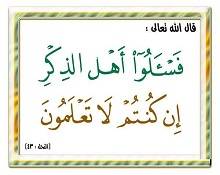
ليس في الإسلام كهنوت يحتكر التكلُّم باسم الله، أو تفسير الوحي، أو الاستئثار بالمعرفة الدينية؛ كما هو الحال في المسيحية، هذا هو الحقُّ الذي عليه الأمَّةُ منذ وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكن هذا لا يعني بحالٍ أن الدين كلأٌ مباح، يتناوله ويفسِّره كلُّ من شاء بهواه ومزاجه، بل إن لشؤون الدين علماءَ متخصصين يعرفون دقائق اللغة العربية، متبحرين في علوم القرآن والسُّنة، كما يوجد متخصصون في الاقتصاد والقانون والهندسة والإدارة وغيرها، لكن من المؤسف أن تجد في زماننا هذا مَن يحترم جميع التخصصات، ويقصد أهلَها عند الحاجة، ويسلِّم بأقوالهم، فإذا تعلَّق الأمر بالمسائل الدينية، نصب نفسَه عالِمًا وفقيهًا ومفسِّرًا ومفتيًا، وسمح لنفسه برفض إجماع العلماء، وجزم برأيه في أصعب المسائل، وكأنه مجتهد ومجدِّد.
يجب أن يكون الأمر واضحًا: أنا ضد التقليد الأعمى، ومع البحث والتحقيق في كلِّ ما يتعلق بالمرجعية الدينية والأحكام الشرعية وتاريخ الأمة، لكن هل من المعقول والمقبول أن يقتحم هذه المجالاتِ من لا يمتلك أدوات البحث والتحقيق؟! هل يكفيه أن يكون قد قرأ رسالة أو كتابًا أو رأيًا، حتى ينتصب للنقاش العلميِّ الذي يحتاج إلى بضاعة راسخة موثقة؟! هل يُسمح له بمثل هذا لو تعلَّق الأمر بمسائلَ قانونية أو طبية مثلًا؟! لماذا يتوقف هنا، ويندفع هناك؟!
أيهما أشدُّ خطرًا بالنسبة للمسلم: المباحث الدينية أم الدنيوية؟! أليس الخطأ في هذه أهونَ من الخطأ في الأولى؟!
من أغرب ما رأيت في حياتي الدعويَّة والعلمية أن غير قليل من الناس يفتقرون إلى أخلاقِ طلبة العلم، وعلى رأسها التواضع، فتجدهم لا يقصدون العلماء للانتفاع منهم، بل لمجادلتهم، فهم لا يعدُّون أنفسهم طلبةً يتعلمون، بل علماء بلغوا درجة الاجتهاد، يُخطِّئون البخاريَّ ومالكًا، وابن تيمية وابن باديس والقرضاوي، ويقولون بكل تبجُّح: هم رجال ونحن رجال! في حين لا يعرفون شيئًا عن قواعد التفسير، ولا علم الأصول، ولا مصطلح الحديث، فصنيعُهم كمن يدرس في الجامعة الإسلامية، ويرد نظريات بيتاغور ونيوتن وأينشتاين، أليسوا سيقولون عنه: متطفِّل؟
إن هؤلاء لا يقصدون العلماء ليعرفوا ما لا يعرفون، أو ليسألوا ويأخذوا الإجابة، ولكنهم يتلقَّفون الشبهات من المستشرقين و"الحداثيين"، وأولئك الذين يُطلِق عليهم الإعلامُ الفرنسيُّ المناهض للإسلام: (مفكِّري الإسلام الجدد)، نعم يأخذون الشبهات حول القرآن والسُّنة والتاريخ، ثم لا يَسألون عن الرد الإسلاميِّ عليها، ولكن يعتبرونها حقائقَ ثابتة، فإذا واجهْتَهم بأقوال العلماء القدامى والمحدَثين، وكيف دحضوا هذه الشبهاتِ منذ زمن بعيد - أعرَضوا وتكبَّروا، وأعرَبوا عن رفضهم لكل المفسرين والمحدِّثين والفقهاء والمفكرين عبر التاريخ؛ لأن المراجع التي يثقون بها هي ماسينيون وجاك بيرك، وأركون وعدنان إبراهيم!
لعل الواحد من هؤلاء "المجتهدين" لا يحافظ على صلاته ولا أوراده، وتديُّنُه رقيق، وبدل أن يعتنيَ بتزكية نفسه، والاستزادة من المعرفة الشرعية، والإقبالِ على الاستقامة، تجده يخوض في المسائل العويصة التي تنقطع فيها أعناق الإبل، ويرفض تراث المسلمين كلَّه بدءًا بترتيب المصحف وثبوت السُّنة النبوية، وغزوات الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ومكانة الصحابة، وانتهاءً بالأحكام الشرعية المتعلِّقة بالمرأة وغير المسلمين والرِّدة، ومرورًا بنزول المسيح وظهور المهدي...كلُّ هذا لا بد من إعادة النظر فيه؛ لأنه غير ثابت، بل هو نتيجة تلاعب السياسيِّين والفِرَق المختلفة! وليس للأمة ثوابتُ إذًا، وهي تموج في الخطأ منذ نشأتها، ولم يكتشف الحقيقةَ إلا هؤلاء المتأخرون الذين يسْتقون "الحقائق" من المستشرقين والشيعة و"القرآنيين" والقديانيَّة.
إنه الشذوذُ الفكريُّ المنبعث من قلة البضاعة العلمية، وضَعف الإيمان الذي يجعل أصحابه يقتحمون المزالق الخطرة بكل خفَّة، وكأن الأمر رياضة أو تسلية، وليس دينًا، ناقشَني أحدُهم - وهو يعمل في ميدان لا علاقة له بالدراسات الشرعية - في قضية الجهاد، وجزم بكلِّ قوة - كما يفعل المستشرقون بخبث ودهاء - أن الغزوات كانت مجرد دفاع عن النفس، أما الفتوحات، فهي عدوان خالَف فيه المسلمون الهدي النبويَّ، فسألته عن غزوتي حُنينٍ وتبوكَ، وقد كان الجهاد فيهما استباقيًّا وليس للدفع - والظاهر أنه لم يكن يعرف عن ذلك شيئًا، ثم قرأ عنه وتأكَّد من صحة كلامي - وقلت له: هل كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - مخطئًا إذًا؟! فردَّ عليَّ بتوتُّر واضح: إذا كان الأمر كذلك، احمِلوا السلاح، وقاتِلوا العالم كلَّه! ومِن ثَمَّ فإن وجه الخطورة في كلامه أنه لا يسلِّم لحكم النبيِّ، بل يُحكِّم عقله، أو بالأحرى عقلَ غيرِه، ومع ذلك فهو مسلم، بل هو وحدَه المسلم، ونحن جميعًا غارقون في الدجل والكذب والتحريف، وعلى رأسنا العلماء والفقهاء والمفسِّرون، والدعاة والمفكرون! تفاسيرُنا كاذبة، سُنة نبيِّنا محرَّفة، فقهُنا مغشوش، تاريخنا مزوَّر، ومِن ثَمَّ إسلامُنا كله لا وزن له، هذا ما اكتشفه في القرن الخامس عشر "مسلمون" قلما قرؤوا القرآن، أو اطلَعوا على السُّنة.
أريد أن أؤكد لإخواني أن مداخل الشبهات سهلة، لكنها دهاليز لا يُحسن الخروجَ منها إلا مَن وفَّقه الله - تعالى -، ومن كان غيورًا على دينه، فليتعلمه من مصادره التي أجمعت عليها الأمةُ، وليَتركِ اصْطياد الشبهات والمسائل الشاذة؛ فإنها تُقسي قلبه، وتلوِّث عقله، وتُبعده عن جمهور الأمة، وتحشره مع الطوائف الشاذة، والتواضعُ أمام العلم والعلماء وتراث الأمة العلميِّ: يَعصم من الزلل، ولو اشتغل كل واحد منا بالمجال الذي يعمل فيه، وأتقن أداءه، لكان أفضل من تركه والغوص في مسائلَ العلمُ بها لا ينفع، والجهل بها لا يضرُّ، وقد زاد الطينَ بِلَّةً ما وفَّره الإنترنت من فضاء مفتوح لشباب أغرار، وكهول متطفلين، اطلعوا على صفحات معدودة من كتب، فحسِبوا أنفسهم علماءَ محققين، وفقهاءَ مدققين، يأتون بما لم تستطِعْه الأوائل، وكلامُهم في الحقيقة صريرُ باب، وطنينُ ذباب، لو كانوا يعلمون!
ومن أنفع الطرق في التعامل مع هؤلاء: تركُ مناقشتهم وجدالهم؛ لأنه لن يزيدهم إلا استكبارًا، أما ما يحتاج إلى مراجعة من مسائل الدين والتاريخ، فيُرَد إلى أهله، وعلينا أن نُقبِل عليهم لنتعلَّم لا لنتعالم؛ (
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
) [النحل: 43]، (
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
) [النساء:83].